مع بداية التباعد الاجتماعي الذي فرضته جائحة كورونا، بدأت في الجزائر ملامح مشهد ثقافي "تفاعلي"، يعتمد على الندوات الفكرية والورشات الثقافية التي تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي.
فيصل الأحمر: يبدو أن الجميع كان مستعدًا لعدم الخروج وممارسة التواصل المفرط افتراضيًا
وفي حواره لـ "الترا جزائر"، يتحدّث فيصل الأحمر عن المشهد الثقافي الجديد الذي فرضته كورونا، وعن اهتماماته في الرواية والشعر والفلسفة، وعن السيرة الذاتية، وبعض القضايا ذات الصلة.
اقرأ/ي أيضًا: حوار| أمل بوشارب.. فتحت عيني على عالم مليء بالكتب
ويساهم الروائي فيصل الأحمر، ضمن هذا المشهد الجديد، بتنشيط بعض الورشات للكتابة الروائية، والموجهة خصيصًا للكُتّاب الجدد. وعلى عكس الكثير من "المتشائمين"، يؤكّد لحمر أن "الكتاب في صحة جيّدة لأسباب لا أحد يعلمها بالتدقيق".
- ألقيت مؤخّرًا محاضرة "تفاعلية" عن "تقنيات كتابة رواية"، هل هناك وصفة جاهزة لكتابة رواية "نموذجية"؟
الرواية النموذجية مفهوم هلامي، لأنها حكم قيمي وحكم القيمة أساسه التموقع. هنالك روايات شديدة التأنّق والنظافة، كروايات روسو تورغنيف أو بعض نتاج زولا والرومانسيين قبله، أو مجمل ما كتبه الآباء المؤسّسون العرب: جورجي زيدان والمنفلوطي وجبران، وهنالك روايات تحب تمريغ أنفها في التراب كنصوص سالنجر وبوكوفسكي وبوروز والواقعيين الإيطاليين.. ولا شيء يجمع بين هذين المزاجين الروائيين. إذا أنت وضعت في دماغٍ واحدٍ رشيد بوجدرة ومالك حداد، سيحدث ارتجاج في الجمجمة، بسبب البون الشاسع بين عالميهما.. ولا أحد يملك أن يقول عن هذا إنه هو الجميل، وعن المنافي له إنه خردة أدبية. المعوّل عليه هو أن كلّ رواية كتبت لقارئ ما. نتعدد فتتعدد أذواقنا وتتعدّد النصوص التي تستجيب لهذه الأذواق. هذا كل ما في الأمر.
الورشات التي نشطتها، كانت في معظمها وقوفًا للكتاب الجدد، وللقراء المواربين أمام الباب المواربة للكتابة على العتبة الأولى، التي هي إجابة على أسئلة: ماذا أكتب؟ هل هذا جائز؟ كيف نتدرج صوب الجملة الأولى ثم منها صوب غيرها. أما الفقرة الأساسية في هذه المحاورات اللذيذة، فهي النصيحة التي ثمنها مليون دولار: اقرأ روايات كثيرة.. اقرأ.. اقرأ.. اقرأ (حتى إن كان الصوت الصاخب الذي بداخلك يصيح بأعلى ما فيه من قوة: ما أنا بقارئ).
- وكيف تقرأ هذا المشهد الثقافي الافتراضي الذي عجّلّت به جائحة كورونا؟ وهل الساحة الثقافية في الجزائر كانت مستعدة له؟
في المطلق أنا متفائل جدًا، فالكتاب في صحّة جيدة لأسباب لا أحد يعلمها بالتدقيق. الروايات تملأ الرفوف، وإنسان القرن الحادي والعشرين الذي بشر الجميع بأنه إنسان بعيد عن الكتاب، اتضح بأنه إنسان كتبي بامتياز؛ فالجميع يمارسون كتابة روايتهم أو قراءة رواية شائعة ما. الجميع يحملون كتابًا ويتصورون معه وينشرون صور الكتاب على وسائل السوشيل ميديا. كيف تغيرت السويشل ميديا إلى أداة للدعاية للكتاب؟ سؤال جدير بالتحليل.
ما ألاحظه حول ما تسأل عنه يا صديقي، هو سرعة التجاوب مع متطلبات الحجر هذه. يبدو أن الجميع كان مستعدًا لعدم الخروج، ولممارسة التواصل المفرط من البيت ومن وراء الحاسوب أو الهاتف الذكي.
شخصيًا، أتلقى يوميًا دعوات لتنشيط ندوات أو تسجيل محاضرات أو التدخّل في بعض الشأن العام.. وما أرفضه أكثر مما أقبله لأسباب في معظمها مرتبطة بالجدول الزمني، وما لا يسمح به.
المشهد أخطبوط كبير يا صديقي. يحوي كلّ شيء ولا شيء. يجمع الشيء إلى نقيضه بأريحية تامة. أمّا المؤشرات والإرهاصات وحتى العلامات العارية الدالة على الوضع فيغلب عليها أن تكون تنطق بالإيجابية. فالمجتمع البشري يبدو مستهلكًا تم ترشيده. لحق به الحذر من السقوط السريع، وصار حذرًا وخائفًا، والعذاب والمعاناة طريق مضمون تاريخيًا لتحسين الظرف البشري.

- على ذكر "كورونا"، كيف كيّفت برنامجك اليومي مع "الحجر الصحي" الذي فرضته الظروف، وقنّنته السلطات السياسية؟
في ظلّ العزل الاضطراري أحاول مقاومة النزوع الجنوني الذي يعتريني، وربّما يعتري الناس أجمعين، فيما قيم الحياة المعهودة تتفتت بسرعة: لا لقاء لا عمل، لا زيارات لا سفر، لا مسجد لا مقهى لا جامعة لا حديقة عمومية.. لا أصدقاء، وكل من تلاقيه، تتردّد في السلام عليه، بإملاءٍ من الحراس الجدد للسلامة الصحية العالمية.. الواقع هو أنني في ظلّ العزل الصحي داخل مكتبي/مكتبتي، أواصل فعل ما تعودت عليه، فأنا أصلًا شخص حياته الطبيعية تجبره على كميات كبيرة من العزل الاجتماعي. ومشكلتي هي فيروس القراءة والكتابة. فيروس صحي جدًا – بحسب مختّصين- ولكنه قاتل للمخالطة ولتطوير الحسّ الجماعي.
رفقائي اليوميين، هم أشخاص مثل ألدوس هكسلي، وجورج أورويل، وروبرت هاينلاين، وفيليب ديك، وآيزاك آزيموف، وفرانك هيربرت، ودين كونتز، وباقي كتاب الخيال العلمي.
رفقائي الآخرون هم الفلاسفة. أناس دفعوا بعيدًا بالحديث التراثي الذي بلغ صداه الجميل حدًا نسبته إلى النبي محمد: خذوا الحكمة من أفواه المجانين... وهؤلاء هم فقط جماعة متخيّلة يعجز الواقع عن إدراجها اجتماعيًا فيعزلها في المخالطة، ثم التواصل، قبل إن يدخلها الحجر العقلي.
ما هذا؟ هل نحن مجانين نعد بالملايير؟ أمر جدير بالتفكير فيه للسبب البسيط الذي هو أن المجانين في أغلب الأحيان، لا يعلمون تمامًا بأنهم مجانين.
هكسلي، وأورويل، وهاينلاين، وديك وآزيموف، وهيربرت، وكونتز وكتاب الخيال العلمي الكثيرون الآخرون، كلّهم علموني أن أنظر إلى الحجر الصحي والانعزال الاجتماعي كسيناريو ممكن للحياة المستقبلية. حياة تتميّز بالتفاوت في الفرص، بفساد الكوكب، بالكوارث الإيكولوجية، باللامسؤولية السياسية الكونية الشاملة في التخطيط للمستقبل: مستقبل يسوده الفقر والوسخ وتنتشر فيه الأوبئة، والجنون في الاستعمال اللاأخلاقي للتطوّر العلمي. مستقبل بقدر ما تصورته يوتوبيات القرن المتفائل المليء بالتقدّم العلمي والصناعي والاختراعات البديعة، التي تعد بالغد الأفضل ( القرن19)، كيوتوبيا إيجابية بفضل العلم، بقدر ما حذرت منه اليوتوبيات المضادة للقرن العشرين، أو الديستوبيات التي رأت الحربين العالميتين، ورأت ما يمكن للعلم أن يفعله بيد إنسان يتطور جسمه، بمعزل عن عقله وروحه، وبمعزل حتى عن حظه من الفلسفة ومن الإيمان.

- عودة إلى "التفاعلية"، كنت قد كتبت في زمن "الورقة والقلم" رواية في الخيال العلمي "أمين العلواني"، تتحدث فيها عن هذه الأجواء، كيف تقرأ تلك الرواية في ظل هذه المستجدات؟
منذ أيام كتب حول هذه الرواية، الكاتب والناقد المصري عماد الدين عائشة، لإحدى المجلات الإنكليزية دراسة مطولة، وكان وهو يحررها على اتصال بي، استنطقني في هذه القضية بالذات، فقلت له كلامًا أردده هنا (هو مثبت في ملحق الدراسة).. ما كان من أنماط التواصل الحرّ، ومن التواصل بالصور، وما كان من ذوبان الأقاليم العتيقة والدول الوطنية لفائدة تشكيلات سياسية جديدة، كل ذلك معروف في ميدان الخيال العلمي، ولدى القراء والمعجبين والمتحمسين لهذا النوع (ما يسمى في المعجم الإنكليزي fandom)، سيكون من الكذب على الذات وعلى التاريخ أن أدعي بأنني اكتشفت جديدًا وأنا أصور عالم الإنترنت في 1990/2000 أيام تحريري لروايتي "أمين العلواني".
كل ما فعلته، كان استغلال أحلام المجتمع العلمي العالمي، الذي كان يحلم بالتواصل المفرط والتواصل الآني، وبالتدخل اللحظي في كل قطاعات الحياة دون التقطع والمماطلة.
وإجابة على سؤالك بالتحديد، أعتقد أنني كنت حذرًا مما حدث لكثير جدًا من كتاب الخيال العلمي الكبار جدًا؛ فمرور الزمن غالبًا، ما يجعلنا نضحك على خيبة نبوءات هؤلاء الأفذاذ.. لذا مالت روايتي صوب طرح المسألة الفلسفية، المتعلقة بالكتابة بالمسؤولية الأخلاقية على العالم، والمتعلّقة بتحولات وظائف النخب بتحول العالم.
جعلت جزءًا هامًا من جهدي الكتابي ينصبّ على مسائل التنويع الشكلي والتلاعب بجغرافيا النصّ، في إطار يمس بالحكاية والقّصة والدلالة العامة وحتى الدلالة الفلسفية المرجأة للنص. وهذه مسائل لا زال الدارسون يتناولونها بالدراسة (أعتقد أن أمين العلواني، من الروايات التي درست كثيرًا في الجامعات عندنا وحتى في الخارج).
- تكتب أسبوعيًا "زاوية فلسفية" في الصحافة الجزائرية، كيف ترى واقع سؤال الفلسفة في الأدب الجزائري؟
إذا بحثنا عن الإجابات السريعة، سنقول إننا بعيدون عن هذا النوع من السؤال، أمّا عن الإجابات المتأنية، فإنها ستجعلنا نلاحظ أن الفلاسفة قد دخلوا المكتبات الجزائرية (والعربية عمومًا) من الباب الواسع. أقسام الأدب تأثرت كثيرًا بالميل الكبير لكثير من الفلاسفة، إلى ترك التقنيات واتجاههم إلى الإنسانيات: هايديغير، غاسطون باشلار، ميرلو بونتي، جورج شتاينر، لوكاتش وانتهاء بمارتا نوسباوم.. وحتى جماعة اللسانيات من أمثال نوام تشومسكي، وتودوروف، وكلود حجاج، نراهم يتركون بأريحية تامة اللسانيات ملتفتين إلى أشياء الحياة الملموسة المحسوسة والمحدوسة (الإنسانيات)... اعتقد أن هذا هو أحد الأسباب التي حوّلت الفلاسفة إلى نجوم المكتبات على أيامنا.
ويضاف إلى كلّ هذا عنصر على درجة عالية من الأهمية، هو تضاؤل دور التيارات الإسلامية الراديكالية التي كانت تعلن الحرب على العقل والتفكير والفلسفة. وسقوطها سيفتح الباب للفلسفة واسعًا كما هو متوقّع.
بالنسبة لي أنا أكتب أعمدة فلسفية، تحاول اللعب على ثلاثة حبال: نقد الميراث المعاصر للفلسفة من منطلق أنني أرى أن إنسان اليوم قد حوّل نفسه إلى مركز للعالم في محاولة خطيرة لمحو التاريخ وتحويل الحاضر إلى منعرج تاريخي يختزل الأزمنة كلها. وكذا محور الانفتاح المرح على الأدب كمادة ثرية للتفكير في العالم؛ مادة متعددة الأطياف والأدوات تخلق كثيرًا من زوايا النظر المثيرة، لأن الأدب خزّان قوي وفصيح للتجربة البشرية. وعلى يد ثالثة أحاول مقاربة موضوعاتي من زاوية المشتغلين على الدراسات الثقافية: زاوية متعدّدة التخصّصات، تهتم بصلات الخطاب مع السلطة، وبتفكيك شبكات اشتغال الأيدولوجيا داخل النصوص والمنتجات الثقافية في شقّها النصوصي.
- تكتب الشعر والرواية والقصة والدراسات الأكاديمية، وتشتغل على الترجمة، كيف تفرق دمك بين كل هذه "القبائل"؟
في القاعات الخلفية للكتابة، نحن لا نطرح كثيرًا السؤال حول الجنس الذي نكتب في إطاره. الجمهور يحبّ الروايات والتواصل الحديث مولع بالشكل الروائي، لهذا تجدنا نحن الكتاب جميعًا روائيين، ثم شيئا آخر يضاف إلى الرواية.
في الذاكرة الثقافية للعرب، وللعالم أجمع، يوجد كمّ كبير للشعر، لذا فأنت لن تتواصل مع الذاكرة البشرية بدون العروج على سماوات الشعر... وأنت حين تكتب عن اللقاء العجيب بين الفلسفة والأدب، بلغة أدبية وبمزاج إنسان هذا الزمن، الذي يقف على تراث كبير من المعارف، ومن القدرة على استنطاق المواقع الثقافية فأنك تجعل الكتابة ساحة للعجائب، كالتي في مراكش أو التي في مدينة فيكتور هيغو في "نوتردام الباريسية".
نحن أبناء زمن متخم بنزعة قهر العجائبي، والتخلّص من القدرة على الدهشة (أم تراه التزام بالدهشة؟).. يروقني ما كانت إيريس مردوخ تقوله: "كل الحبكات صارت معروفة، بقيت أمامنا صياغة الحكايا، ودهشتنا أمام اللغة وحدها قادرة على ضمان الدهشة، التي لابد منها في الكتابة وفي الحياة".
الكتابة عندي شخصًيا، هي نوع من عمل المتسكعّ الذي أغرم به القرن التاسع عشر، أو ذلك المتسكّع المتوحّد الذي في كتاب جان جاك روسو.. ولكنني متسكّع بين الكتب ومحتوياتها الشكلية.
اقترح رولان بارت ذات يوم، فكرة متميزة جدًا هي تسمية الكتاب باسم جديد، خال من التقاليد الكتابية وتقاليد تاريخ طويل للممارسة تحت لافتة "الكاتب".. وكان مصطلحه هو scripteur))، في حوار مغلف مع الأصل اللاتيني السابق لتقاليد الكتابة المتراكمة عبر القرون؛ أو المرقّش إذا جازت التسمية ذات الأصول العربية التراثية (وربما في تسمية المدون المعاصرة رد فعل إيجابي على قلق رولان بارت من تسمية كاتب).
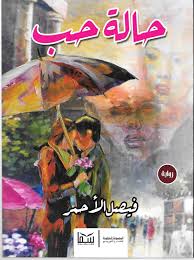
- أخيرًا، أصدرت قبل سنة كتاب مذكراتك "خزانة الأسرار"، ألا ترى أن استعجلت كتابتها وأنت في الأربعينيات من عمرك؟
أنا في الثامنة والأربعين. ولي ثمانية عشر كتابًا. ما يحدث هو أن بعضنا يعيش بسرعة معينة. والبعض يدقّق مع الثواني أكثر من الغير. مع هذا فأنا لا أدري ما الذي دفعني إلى هذا النوع من الكتب. هو ليس سيرة ذاتية بالمعنى المعهود. هو محاولة لتضميد بعض الجروح التي تصرّ على أن تنز باستمرار. شخصيًا لي مشكلة كبيرة مع الذاكرة الأولى. ذكرياتي كلها تبدأ من السنة التاسعة. هذا وضع غير معهود. حاولت العلاج عن طريق الكتابة لما رأيته من قدرة الكتابة على تحريك سواكن الذات والدخول إلى الجيوب الخفية. على محاورة الجيوب الداخلية للذاكرة التي نظنها نائمة.
من جهة أخرى، أنا من النوع الوجداني. أكتب بضغط من حالات تستدعي الكتابة. أكتب لأنني أشعر بأن الكتابة واجبة. أكتب لأنه لا يوجد حلّ آخر في تلك اللحظة.
في الخزانة كثير من الجروح، ولكنها ليست جروحًا صاخبة كما يحدث لبعض الكتاب على هامش الحروب أو الثورات، أو حركات الاحتلال التي تؤججها التصفيات العرقية وما شابه ذلك.
يغلب على جروحي أن تكون جروحًا أصيب بها المحيط. وربما التفسير الأقرب إلى الحقيقة فيما يتعلق بي، هو كوني من الشخصيات التي تتلبس بأمراض المحيط. الشخصيات التي تصيبها أمراض المحيط الأكثر خفاءً.
فيصل الأحمر: أكتب لأنني أشعر بأن الكتابة واجبة، و لأنه لا يوجد حلّ آخر في تلك اللحظة
لي طريقة مجنونة في التلبس بأحزان الناس. في الانتشاء لانتشائهم. في الاهتمام بما يقض مضاجعهم والسعادة بأفراحهم. وأعتقد هذه خصوصية مفيدة على المستوى الكتابي، وهذا ما أعطى شكل الكتاب الذي يبدو مليئًا بصور أناس من المحيط المباشر. أناس يبدو أنهم قد لعبوا دورًا هامًا في رسم ملامح خزانتي الشخصية.
اقرأ/ي أيضًا:
